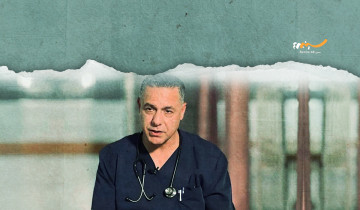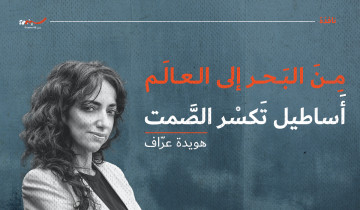عامان على تَفكيك الاقتِصاد وتَجْفيف مَصادر تَمويل السُلطَة الوَطنيّة الفِلِسطينيّة

مَثَّل الاقتصاد الفِلسطيني الناشئ في سِياق اتّفاق أوسلو ترجمةً فعليّة لعَلاقَة تبعيّة استعمارية أُعيد إنتاجها ضمن إطار سياسي، سُمّي مجازًا "عمليّة سَلام". حيث تمّ الانتقال من الاحتلال العسكري المباشِر إلى نمط جديد من التحكّم: تحكّم بدون إِدارة مباشِرة، وتبعيّة اقتصادية بدون سيادة سياسيّة. وهنا، يتّضح أن بروتوكول باريس، لم يكن يومًا مُلحقًا اقتصاديًا، بل آلية قانونيّة مَفروضة –حتى إنّ بَدَا أنّه تمّ الاتفاق عليها- بهدَف واحد هو تَقنين التبعيّة.
فالاتفاق، الذي أُبرم بين طرَفين غير متكافئين، لم يكُن يَهدف إلى بناء اقتصاد فلسطينيّ مستقل، بل إلى ضَمان اندماج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصاد الإسرائيلي من مَوقع دونيّ. لم يُمنَح الفلسطينيون الحقّ في أَدوات السياسة الاقتصاديّة الأساسية: لا سياسة نقدّية، ولا سيطرة على الجمارك، ولا حقَّ ضَبطِ تدفّق السّلع ورأس المال. حتى ضريبة القيمة المُضافة صُممت بما يتناسَب مع مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي. والأَسوأ مِن ذلك أن إسرائيل احتفظت بحقّ جباية العائدات الجمركيّة وتحويلها، متحكّمة بتدفّق الأموال وِفق اعتبارات "أمنيّة"، مما جعل الماليّة العامة الفلسطينية عُرضة دائمة للابتزاز.
ليسَ من المبالَغة ولا المبكّر القول إن الاقتصاد الفلسطيني، في صيغته الرّاهنة، لم يعُد يُعاني من أَزمة مرحليّة، بل باتَ يرزح تحت وطأة أزمة بنيويّة مركّبة تَنطوي على عناصِر تفكّك اقتصادي تدريجيّ. لا يُمكن فَهم هذه الأزمة إلّا في سياق بنية استعمارية مستمرة، تُعيد إنتاج التبعيّة بأدوات متجددة، أبرزها أدوات السَيطرة المالية (كالمقاصة ودعاوى التعويّضات)، والهَندسة المكانيّة (كالحواجز)، والتّضييق الممنهَج على سلاسل الإنتاج والتوريد.
مع نهاية عام 2023، دخل الاقتصاد الفِلسطينيّ طورًا جديدًا من الانهيار، بِفِعل التّداخل البنيويّ بين أدوات الحرب الإسرائيلية وسياسات الإِخضاع الاقتصادي. فقد أدىّ استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب الاجتياحات المتكرّرة للضفة الغربية، وتَعطيل الحَياة الاقتصادية عبر الإِغلاقات الممنهَجة وتَسريح أكثر من 90% من العمال الفلسطينيين في الداخل والمستوطنات، إلى تَراجع النّاتج المحليّ الإجمالي بنسبة بلغت 33% في ذلك الربع الثالث من العام 2023، لترتَدّ آثار ذلك على مُجمل الأَداء الاقتصادي للعام بأَكمَله بانكماش بَلَغت نسبته نحو 6%، بما يعادل خسارة تُقدّر بمليار دولار مقارنة بالعام 2022 (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023).
على مدار العام 2024، كَشَفت المؤشرات الكليّة عن حالة تدهور اقتصادي غير مسبوقة تمثّلت في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27%، وهي أكبر نِسبة منذ اجتياح عام 2002. في قطاع غزة، بَلغ الانكماش الاقتصادي نسبة تَجاوزت 82% في عام واحد، وهي نسبة لا تَعكِس فقط آثار العُدوان الإسرائيلي المستمِر حتى اللحظة، بل الانقطاعَ الكامِل لعلاقات الإنتاج، وانهيار سَلاسل القيمَة (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية، 2025).
تَكشف مُعطَيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن سوق العَمل في الضفة الغربية، رَغم تسجيله نموًا سنويًّا في أَعداد العاملين بَلغ 9.5% ليصل إلى نحو 692.9 ألف عامل في الربع الأول من العام 2025، لا يَزال أسير بنية هشّة تتأثّر بتقلّبات الاقتصاد السياسي الفلسطيني، إذ يَعمل 5.8% من هؤلاء في إسرائيل والمستوطنات، ما يرسّخ التبعيّة التَشغيليّة. وعلى المستَوى الفَصلي، تراجَع عدد العاملين بنسبة 3.3%، فيما يُظهر التّحليل السّنوي (باستثناء عمال إسرائيل) انخفاضًا من 680.8 ألف في الربع الأول من العام 2024 إلى 654 ألفًا في الربع نفسه من نفسه 2025، نتيجة فقدان وظائف، خصوصًا في قطاع الخدمات والبناء والتشييد.
على مُستوى الإنتاج، شَهِدت الأنشطة الاقتصادية تراجعًا حادًّا. فقد انخفض الناتج المحلي من 13,183.6 مليون دولار في العام 2023 إلى 9,454.5 مليون دولار في العام 2024، أيّ بانكماش نسبته 27%. وتضرّرت قطاعات الإِنشاءات والصناعة والزراعة والخدمات بشكل خاص، مع تَراجعٍ بَلَغَت نسبته 46% في قطاع البناء، و33% في الصناعة، و32% في الزراعة. في المقابل، بَقِي القطاع الزراعي أَقَلّ القطاعات تراجُعًا. (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية، 2025).
ما يُعَزّز فرضيّة الانهيار البنيويّ هو أن النّاتج المحلي الإجمالي في العام 2024 أَصبح يقارب مستوياتِه المسجَّلة عام 1994، وهو العام الذي شَهِد تَأسيس السلطة الفلسطينية. بَعد أَكثر من ثلاثة عقود من "بناء المؤسسات" وما رُوّج لَه من مسارات تنمويّة، يعود الاقتصاد الفلسطيني إلى نقطَة الصّفر تقريبًا، الأَمر الذي يَطرح تساؤلات عميقة حول ماهيّة النمو الذي تحقّق خلال هذه الفترة، ومدى ارتباطه ببنيةٍ اقتصادية ريعيّة في جوهرها.
فهذا النمو، في معظَمِه، لم يَكن ثمرَة لتوسّع الإنتاج أو تراكُم رأس المال الوطني، بل نتيجة تدفّقات مساعدات خارجية، وعوائد تشغيل مرتبِطة بالاقتصاد الإسرائيلي. بذلك، يتّضح أنّ الأزمة الاقتصادية الرّاهنة تتصل عضويًا بطبيعة البنية الاقتصادية التي نشأَت بعد أوسلو، وتَمَأسست ضِمن نموذج ريعيّ هشّ لا يَقوى على الصّمود في وَجه التحوّلات أو الصّدمات، سواء أكانت سياسية أم أمنيّة أم مالية.
تَتَجلى هَشاشة البُنية المالية للسلطة الفلسطينية في اعتمادها البنيويّ على مصادر تَمويل خارجيّة وغير سياديّة، تَجعلها عُرضة لابتزاز مزدَوَج: إسرائيلي مِن جهة، ومانحين مِن جهة أخرى. فالمقاصة التي تُشكّل أكثر من 67% من مُجمل إيرادات السلطة، تَخضَع كليًّا لتحكّم الاحتلال الإسرائيلي. لم تَكن أَزمة المقاصة المتكرّرة سِوى تَعبير عن هذه التبعيّة الهيكليّة، لكنّها تفاقَمَت بَعدَ التّراجع الحّاد في الدّعم الخارجي، الذي انخفض من 27% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 إلى أقل من 3% عام 2024 (وزارة المالية الفلسطينية، 2008،2024) والذي تمّت تَغطيته بمَزيد من الاقتراض الدّاخلي، ما أدى إلى تضخُّم القروض المستحقّة على الحكومة لصالح الجِهاز المصرفي.
بَلَغ إجمالي الدين العام للسلطة الفلسطينية حتى نهاية أيار 2025 نحو 45.5 مليار شيكل، تتوزّع على جهات عدّة، أَبرزُها 15.4 مليار شيكل لصالح البنوك (محلية وأجنبية)، و6.6 مليار شيكل مستحَقّات للقطاع الخاص، في حين شكّلت رواتب الموظفين المتراكِمة نحو 5.2 مليار شيكل، إلى جانب ديون أخرى متنوعة بقيمة 18.3 مليار شيكل. يعكِس هذا الحجم من الديون اختناقًا ماليًّا متفاقمًا يَعجز عن مواكبة الالتزامات الأَساسيّة، في ظلّ غياب مصادر تمويل سياديّة (وزارة المالية الفلسطينية، 2025).
في هذا السياق، بَرَزَت أزمة رواتب الموظفين العموميّين باعتبارها أَحَد أَكثر تجليّات الأزمة الاقتصادية حساسيّة وتأثيرًا اجتماعيًّا وسياسيًّا. فقد باتت السلطة الفلسطينية عاجزة عن صَرف الرواتب كاملة وفي مواعيدها منذ أواخر عام 2021، نتيجة نَقص السُيولة وانخفاض الإيرادات، مما فاقَم من حالة الانكماش الاقتصادي نتيجة تراجُع القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع.
تُبيّن هذه المؤشّرات مجتمعةً أن الاقتصاد الفلسطيني لم يَعُد يواجه مجرّد أَزمَة نمو أو اختلال بسبب العدوان فقط، بل أَزمَةَ تفكّك اقتصادي تدريجيّ ناتج عن مَنظومَة احتلال وتبعيّة مُزمِنة، ترافقَت مع غياب استراتيجية وطنية بديلة قادرة على خلق بيئة إنتاجية تحرّرية مستقلة. إن الطبيعة المركَّبة لهذه الأزمة، التي تتقاطَع فيها الاعتبارات السياسية بالاقتصادية، تَستَدعي مراجعةً نقدية للنهج القائم، والانطلاق نَحو رؤية تنمويّة بديلة تَضَع التحرّر من التبعيّة في مركزها، وتعزّز من قدرة المجتمع على الصّمود والإنتاج وإعادة بناء مؤسسات اقتصادية مستقلّة وشفّافة.

د. نصر عبد الكريم
حاصل على شَهادة الدكتوراه في الاقتصاد المالي من جامعة جنوب الينوي في الولايات المتحدة عام 1992، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تكساس للعلوم والتكنولوجيا عام 1984، وشهادة البكالوريوس في المحاسبة والإدارة من الجامعة الأردنية عام 1980.
شغل مواقع متقدّمة في أبرز الجامعات الفلسطينية، وفي مؤسسات ومراكز بحثية محلية وعربية عدّة، إلى جانب
عمله مستشارًا للعديد من المؤسسات الوازنة مثل (UNDP) والبنك الدولي وسلطة النقد وصندوق الاستثمار الفلسطيني والاتحاد الأوروبي.