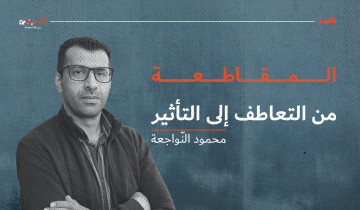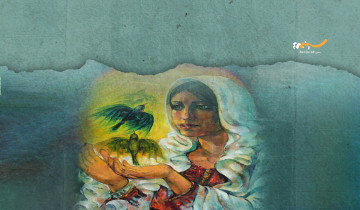التّضامُن العَرَبي مَع فِلِسطين: حَولَ الفِصام المُزمِن بَين القمَّة والقاعِدَة

في الوقت "بدل الضائع،" عُقدت القمم العربية خلال حرب الإبادة هذه، دائمًا متأخرة، دائمًا دون نتائج تُذكر، والدليل: حَرب إبادة دامَت عامين. بعد استشهاد ما يِقارب سبعينَ ألف فلسطيني، انضمّ زعماء الدول العربيّة، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمّة شرم الشيخ للسلام، مصفّقين له، ومُعربين عن دوره الإيجابي في وقف إبادة قطاع غزة (ولو لم يَصِفوها هكذا). في اليوم التالي، تَجَمهَر طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة احتجاجاً على استضافة الجامعةِ السفيرَ الأمريكي لدى دولة الاحتلال سابقًا، دانيال كيرتزر، نظرًا لتأييدهِ دولةَ الاحتلال.
لم تكن فلسطين يومًا قضيّة الفلسطينيين وحدهم، بل ما زالت تَحضر، كنموذج رمزيّ، ومثال حيّ لجميع النضالات العربية وغير العربية ضد الإمبريالية الغربية، حتى لتلك الدول التي دَخَلت في مراحل "ما بعد الاستعمار"، في إطار سعيها لكَسر الأغلال والانفكاك عمّا هو غربيّ إمبريالي بتجليّاته كافّة.
رَغم حجم التضامن الحاليّ، فإن فجوة كبيرة ما زالت قائمة بين التضامن الشعبيّ القاعدي مع فلسطين بآليّات تعبيره المختلفة، والأنظمة العربية وآليات تعبيرها. تَكاد تكون حالات مِثل العدوان "الحالي"، والاعتداءات الأخرى من قَبْله على مدار عمر القضية الوطنية منذ أكثر من 75 عامًا، هي الاختبار الأبرَز لقياس الانتماء لفلسطين والتضامن الفعليّ معها.
كَيف نقرأ التضامن نظريًا؟
يعود الاستخدام الأوّل لمَفهوم التضامن لعالم الاجتماع أوغست كونت، لكنّ المعالجة الأكثر كلاسيكية للمفهوم تعود لإيميل دوركهايم الذي أجرى مقارَنة بين المجتمعات التقليدية البسيطة والمجتمعات العضويّة الحديثة بالاستناد لطبيعة التضامن. يُحيل التضامن هُنا إلى روابطَ مدعومة من منظومة قيَم ومعايير مشتركة تساهِم في تماسك الأفراد، أهمها "الضّمير الجَمعي".
أما الفيلسوف الاجتماعي لاري ماي فيُضيف إلى مَفهوم "المشترَك" في التضامن، فكرة الجهوزيّة لتقديم الدعم استنادًا لما هو "مشترك" بين الأفراد. واسترسالًا، وبتجاوز النطاق المحليّ للمجتمع، يرى شولتز أن التضامن السياسي، يتخطّى الحواجز المحليّة، إلى تحرّكات الناشطين وأعضاء حِراك ما، في مواجهة اضّطهاد مجموعة ما، وهذا ما يسميه "تضامن خارج المجموعة"، والذي قد يتعداه إلى التضامن العالمي. هذا ما يُمكن ملاحظته عند نقاش حالة التضامن مع فلسطين، باعتباره يعبّر عن تضامن يتعدّى الحدود القومية لنشطاء ضد الاضطهاد.
بشكلٍ موازٍ مع تغيّر موازين القوى الدولية لصالح الشعوب المضطَهَدة في العالم الثالث، ازداد التضامن مع فلسطين كإحدى قضايا المضطَّهَدين، خاصة بعد اتّضاح حقيقة الممارسات الصهيونية القائمة على الإبادة الجماعية والتّطهير الِعرقي لشعب فلسطين، الأمر الذي يؤكّد أن الرابط بين الشعوب يتجلّى في نهاية الأَمر بالوُقوف إلى جانب من يقاتِل من أجل مختلف الحقوق، لذلك يعرّف ديفيد فيذرستون التضامن بكونه علاقةً تُصاغ في سياق الصّراع السياسي الذي يَسعى إلى تحدّي أَشكال الاضطهاد.
كثيرًا ما يُحلَّل - ويُمارس- التضامن العربي مع فلسطين استنادًا إلى مثلثِ أبعادٍ يُمثّله، ويشمل: اللغة، والثقافة السائدة بما يتضمّ، المكون الديني بطبيعة الحال، إضافة إلى تعرض الدول العربية جميعها للهيمنة الاستعمارية، مما يُشير إلى جماعيّة التعرّض لاضطهاد مشابه من حيث الممارَسة والمَصدر، خالقًا تضامنًا بين الشعوب المستعمرة.
في سياقٍ شبيه، لكن على نطاق أَوسَع، تتم الإشارة إلى أن ما يحفّز التعاطُف والتضامن الكبير مع الشعب الفلسطيني، هو اعتباره شعبًا مسلمًا، ويعاني فيه المسلمون من اضطهادات تشبه اضطهادات شعوب مسلمة أخرى في البوسنة والهرسك، وكشمير مثلًا، لكن هذا قد لا يكون دقيقًا في حالة اللغة والدين كبُعدَين، باعتبار وُجود مكوّنات الأمة العربية من غير المسلمين، كما تتحدّث أعداد واسعة من المغرب العربي بالأمازيغية، وليس العربية، كما الملايين من الأكراد في سوريا والعراق وتميّزهم اللغة والهوية الكرديّة، وقطاعات من هذه الشعوب، لاعتبارات عديدة لا مجال لتناولها هنا، باتت تعرّف نفسها بهويتها الفرعية، لا بالهوية العربية الجامعة.
هُنا يحضُر التضامن بكونه نتاجًا لـ "الذاكرة الجمعية" (Collective Memory) لمجموعة من الأفراد، إذ تتعدّد الأطر النظرية التي تستخدم الذاكرة الجمعيّة كمدخل لتحليل التضامن بين الشعوب.
يُعلي دوركهايم من شأن "الذاكرة" في بناء التضامن من خلال ما يسميه "طقوس إعادَة التّخليد" (Commemorative Rituals)، ينطَلق من فكرة مفادها أن هناك حاجة لأن يمتلك المجتمع حالة من الإحساس بالاستمرارية مع ماضيه وتاريخه كعامود للحياة الاجتماعية التي يرتبِط بها التضامن، وتعزّز تضامن المجموعة الاجتماعية. طوّر طالبه موريس هالبواك مفهوم الذاكرة الجمعية حين جادل بأن للأفراد ذكريات لا تُفهم إلّا من خلال وجودهم في سياق مجموعة ما؛ إذ يكوّن الأفراد ذاكرتهم من خلال التفاعل الاجتماعيّ، وتلعب هذه الذاكرة دورَ وساطة اجتماعية تربط مجموعة ما.
في سياق فَهم التضامن مع فلسطين، وبالعَودة لهالبواك وتأكيده على كون الذاكرة ترتبط بذاكرة الأفراد التاريخية ومجتمعاتهم، والتي قد تكون مضطَهَدة اجتماعيًا، أو عرقيًا أو لها ارتباط بحالات اضطهاد معينة، تأتي الذاكرة الجمعيّة، والحال هذا، كركيزة أساسية للتضامن كونها تَحمل في طيّاتها "القوة لجسم متماسك من الأفراد".
حَوْل الرّابط الوَثيق بين الذاكرة الاجتماعية والتضامن وعلاقتهما بالذاكرة الجَمعية، يشير إيليوت إلى أن الذاكرة الجمعية تقوّي الروابط المجتمعية، والهويّة المشترَكة، التي تؤدي تدريجيًا إلى تَشكيل رؤى الأفراد حَول العالم، بحيث تدفعهم إلى التضامن مع المجموعات المختلفة. في السّياق نفسه، يتمّ نقاش علاقة الذاكرة الجمعية ودورها في النضالات غير العنفيّة، وهُنا نستذكِر نماذج حركة الحقوق المدنية وحركة النمور السود (Black Panthers)، وحديثًا أكثر حركة حياة السود مهمة (Black Lives Matter)، للتركيز على أهمية الذاكرة الجمعية في تَشكيل التجربة الإنسانية، وبالتحديد للأفراد الذين هم ضحايا لعدم المساواة أو انعدام العدالة. في هذه الحالة العنصرية الممأسَسة وغير الممأسَسة تجاه السود في أميركا، تلعب الذاكرة هنا دورًا مهمًا في نضالهم من أجل العدالة، وتضامنهم مع غيرهم من المضطهدين، كتضامنهم الدائم مع فلسطين. وفي السياق الفلسطينيّ، لعبت هذه التضامنات دورًا نضاليًّا إلى جانب منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان تَمَحوَر حول تبادل "الممارسة الثورية" (Revolutionary Praxis)، التي عمقت الوعي السياسي حول الروابط ضد نُظم الاضطهاد الاستعمارية والرأسمالية الإمبريالية.
يؤطّر إدوارد سعيد الذاكرة بدورها الفاعل في بِناء الهوية الوطنية عَبر ما تَخلقُه من "رواية" حول ما حَصَل في الماضي، ولأهميّة التاريخ المَروي في حَشد الأفراد نحو هدف مشترَك. دَفَعت هذه الذاكرة، على حدّ وصفه، الشعوب المستعمَرَة ذات الماضي والحاضر المُهيمَن عليه من قوى خارجيّة، والتي قَهَرت "الإمبراطوريات الكلاسيكية" ما بعد الحرب العالمية الثانية، لاستحضار ذاكرة هذا النضال وروايته بذاتها.
تستحضر التأطيرات الهوياتية في العلوم الاجتماعية والأنثروبولوجية مفهوم الهوية بكونه مكوّنًا مهمًا في خلق التضامنات بين الشعوب، إذ تُحيل التضامن إلى بُعد هوياتي جامع، متجاوزًا للحدود.
في سياقٍ أوسع من التضامن العربي مع فلسطين، نَجِد أن الهجوم على العربي أو المسلم أو المُستعمَر من قوى غربية إمبريالية هو مواجهة صَريحة ضد هوية جمعية لجماعة مقهورين، يتمّ التّعبير عنه بالتضامن على أساس الإنتماء لإحدى هذه الجماعات.
فالتضامن مع فلسطين ذو بعد هوياتي متشعّب، وقد تجدُ أيٌ من المجموعات الاجتماعية والهوياتية المضطهَدة روابطَ صلة تُبنى عليها أسس للتضامن على أساس التجربة المشتركة؛ فيتضامن المسلمون مع القضية الفلسطينية من مرجعية دينية تُناضل ضد الاضطهاد على أساس الدين، بينما تَتَضامن جنوب أفريقيا مع فلسطين على أساس التّجربة المشترَكة لنُظم الفصل العنصرية المفروضة من الغرب الأبيَض، كما تتضامن شعوب أميركا اللاتينية مع فلسطين من مرجعيّة أيديولوجيّة تَرى في نضالاتها للتحرّر من الهيمنة الإمبريالية صِلَة تربطها بالنضال الفلسطيني ضدّ المشروع الصهيوني.
"فاذهَب إلى قَلبي، تَجِد شَعبي، شُعوبًا في انفجارك"
خرج الآلاف في المدُن العربية منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ليملأوا الميادين معبّرين عن تضامنهم مع غزة، فَمِنَ "الخليج إلى المُحيط، ومن المحيط إلى الخليج"، حسب الجُملة الشعريّة لمحمود درويش في أحمد العربي، نهضت "القاعدة" العربية لتُعِدّ جنازة الرّفض لموقف "القِمَم"، أيضًا بِحَسب درويش.
انتَقَل التضامن في العراق، والأردن، والكويت، والبحرين، واليمن، وتونس وغيرها من الدول مع تَتالي الأيام، من مسيراتٍ حاشدة وجمع تبرّعات وإغلاق سفارات دولةَ الاحتلال في دولهم إلى مواجَهَة مباشرة. فيما كان لليمن، ولبنان دورًا بارزًا في التضامن مع فلسطين على إثر العدوان على غزة. فقد رأينا لأوّل مرّة حشود العراقيين - والأردنيين على حدّ سواء - في أيّام العدوان الأولى تصل إلى الحدود الأردنية مطالِبَة بفتح الحدود مع فلسطين للمشاركة المباشرة في النضال ضدّ الاستعمار.
نَرى بشكل لافتٍ التضامن العربي في دول مثل اليمن، الذي رغم كلّ الصراعات الداخلية والعدوان الخارجي، وما خلّفه من آلام ومعاناة للشعب اليَمني، فإنه لم يكلّ ولم يملّ يومًا عن التضامن مع فلسطين، وبالتحديد في هذين العامين. سريعًا ما يهُبّ اليمنيّون معبّرين عن تضامنهم مع فلسطين في شوارع مدنهم، عبر تنظيمهم مسيرات مليونيّة حاشِدة تهيمن على الشوارع اليمنية، وتنظيم حملات تضامنية واسعة. اللافت أيضًا هو حالة الجهوزية التي أبداها اليمن للنضال جنبًا إلى جنب مع فلسطين، وليس فقط عبر المَسيرات المليونية، بل جهوزية عسكرية تُرجِمَت على شَكل رشقات صاروخية على دولةَ الاحتلال.
كما تَداوَل روّاد منصّات التواصل الاجتماعيّ إعلانات إغلاق -أو تراجع أرباح- شهدتها مجموعة من الشّركات والعلامات التجارية التي تدعَم الاحتلال، أهمّها ستاربكس وماكدونلدز وكارفور، نتيجة حملات المقاطعة الشّاسعة التي فرضتها القاعدة منذ بدء العدوان على غزة، ممّا دَفَع الشركات للإسراع لنفي أيّ علاقات لها مع دولةَ الاحتلال.
وبالطبع، إضافة إلى هذه الإنجازات الحَديثة، تبقى تجربة حملة مقاطعة داعمي إسرائيل (BDS) النموذج الأكثر استدامة لأثر المقاطعة وفعاليّتها على دولةَ الاحتلال. إذا ما أَخَذنا أسهم الشركات كمؤشر لنجاح حركة المقاطعة، فهي في الغالب لا تُظهر أَثَر الحركة على انخفاضها، على الأقل على المدى الزمنيّ القصير. لذا، قد يمُرّ الوقت قبل أن نرى تراكُمات هذه لحركة التضامن مع فلسطين، لكنّ التجربة أثبتَت بما لا يدع مجالًا للشكّ، أن التضامن العربي والعالمي مع فلسطين ذو أهميّة كبيرة لما يترتّب عليه من إنجازات على المستويات الاقتصادية والسياسية/الدبلوماسية، وليس محطَّ استهانة.
لكن محاولات متفرّقة كهذه على المُستوى القاعديّ قد لا تكون كافية لإحداث تحوّلات جذرية، كيفيّة وكميّة، سريعة على أرض الواقع، على الرغم من النجاحات الباهرة التي حقّقتها على مرّ السنين، والتي لا تُناقضها هذه المُحاججة، بطبيعة الحال. علمًا أن هذه الحملة تواجه إشكالية انفصال مَواقف القمّة عن القاعدة، بما يضعف حملة المقاطعة ويَخدم السياسة الصهيونية، فمن المفترض أن يكون لـ"القمة" دور أكبر في حظر الاستيراد، وحظر فتح "الوكالات الإسرائيلية" أو الأجنبية الداعمة بزخم لدولةَ الاحتلال، وقطع العلاقات بشتى أنواعها معها، يَحول ذلك دونَ قدرتها على تحقيق نجاحات على مستويات أوسع على الاقتصاد الكلي على سبيل المثال، وعلى النّقيض، فهو يُعزز إمكانية ديمومَة الاستعمار عبر ازدياد اعتمادِه على مواقف بعضٍ من هذه الأنظمة العربية التي لا تُروج أو تُمارس الانفكاك الاقتصادي عنه، بل تسعى لتوسيع العلاقات معه.
ملاحظة ختامية
كان غسان كنفاني عام 1968 قد أطلق سؤالَه الوجوديّ السياسي بصوت "أبو الخيزران" الممثِّل لعجز الأنظمة العربية، الذي صَرَخ في جثَث الرجال الثلاثة: "لماذا لَم تدقّوا جدران الخزان؟"، وتوالت بعدها التّفسيرات والتحليلات النقديّة التي تكاد تكون أَجْمَعَت على أن سؤالَه هذا يأتي بصيغة مجازيّة تُسائل كلّ فَرد لَمْ يَختَر النّضال المستَمِر، واختار الخَلاص الفرديّ الأَسهَل. في حينها، صوّر كنفاني الشعب الباحث عن الحلول الفرديّة بالرجال الذين لم يدقّوا الخزّان. يعود هذا السؤال ويظهر في كلّ صراعٍ يحتدم ليُظهر المفارقة بين القمة والقاعدة العربية، سؤال يُجيب بوضوح على تساؤلات التّحليل للرمزيّات الروائية التي طرحها كنفاني في حينها، وانعكاسات هذه الحبكات الأدبية في الواقعيّة السياسية الحالية.
في ظلّ الغضَب الشعبي على الأنظمة، وقممها المتتالية والفارغة من أيّ فعل تضامني حقيقي، تأتي الشعوب العربية هذه المرّة، كغيرها من المرّات السابِقَة، لتقرَع جدران الخزّان في وجه الأنظِمة ووجه المشروع الصهيوني، ولِتَغدو "رِجال في الشمس" في الحقيقة "رجال ما بَعد الشّمس"، تطمح بما هو أَبعَد من الشمس، وأَبعَد مما تختزِلُه القمم من "تضامناتٍ" شكليّة، ومتأخّرة، لا تُحدث أيّ تغيرات جذريّة لدعم القضية الفلسطينية ولا تَلجم العدوانية الصهيونية في إبادة الشعب الفلسطيني، وبالتالي تصبح هذه القمم حَجَر عثرة في مواجهة هيمنة المشروع الصهيوني على ما تبقّى من "المحيط للخليج". هنا يُمكننا النظر إلى الأنظمة العربية كحالة مثاليّة لأبو الخيزران العاجز، والتي تعتبر التطبيع أحد نجاحاتها السياسية الكبيرة، وعقد القِمم الشكلية قمّة تضامنها، فاكتفت هذه الدول بعقد "قمم" عديدة تُدين وتَستنكر، كما غيرها من القمم، بينما جاءت القاعدة لتعبّر بشكل مباشر عن إدانتها واستنكارها وتضامُنها بنضال ميدانيّ مباشر، وهذا تشخيص يُحاكي ما عبّر عنه غسان كنفاني عام 1961 في القصّة القصيرة "موت سرير رقم 12" حين كتب: "في الوقت الذي كان يناضل فيه بعض الناس (…) كان هنالك بعض أخير يقوم بدور الخائن". من اللافت أيضًا "تناسي" هذه "القمة" العربية خطة المشروع الصهيوني الأسمى لـ "إسرائيل الكبرى" التي ستلتَهِم جميع دولهم إذا ما سَنَحت لها الفرصة التاريخية ولن تُفرّق بين القمة المطبِّعة أو القاعدة المتضامنة.

أنمار رفيدي
باحثة فلسطينية، حاصلة على ماجستير في علم الاجتماع من جامعة أكسفورد، يُركّز عملها البحثي على قضايا الحماية الاجتماعية، والفقر، والحركات الاجتماعية، والهوية، والطبقات الاجتماعية، والسياسات الاجتماعية والتنموية في السياق الاستعماري.