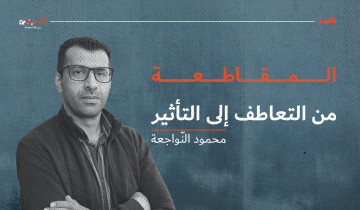مِنَ الكوفيَّة إلى البَطّيخَة: رُموز التّضامُن بَينَ الفاعليّة والاستِهلاك

لغاتٌ أجنبيّة تتقاطَع فوق فنجان القهوة. كلمات كثيرة تمرّ مِن جانبي، وأنا أُراقِب الوجوه التي تُشبه بعضها، ولا تشبِهُني. كلّ شيء مِن حَولي يبدو عاديًّا، حتى البرود الذي يلّف المكان يُشبه الجليد الذي تتركُه الإبادة في داخلك حين تَشهَدها من بعيد، كأنّك مجرّد متفرّج يعيش في عالمٍ موازٍ للكارثة.
ثمّ تلمَح عيني شيئًا صغيرًا: بطّيخة مطبوعة على لابتوبٍ قريب. لحظةٌ قصيرةٌ تَمُدّ حبلًا غليظًا بيني وبين شخص لا أعرفه، وتَفُضّ الإحساس بأنّني غير مرئيّة، تفُضّ الإحساس بالوحدة. كأنّ هذا الرَّمز البَسيط يَفتح طريق أمانٍ بَين مَن يَعيش التّجربة ومن يَحملها عن بُعد.
لا أَعرِف الشَّخص صاحب اللابتوب، ولا إِن كان فلسطينيًّا أصلًا، لكنّ رَمز البَطّيخة يكفي ليقول إنّ القضيّة حيّة في هذا المَكان البعيد، وأنّني لست وحدي من أَحمِلها. في تلك اللحظة البسيطة، يُصبح الرّمز طريقة لتسكين الانفصال الكبير — جسرًا صغيرًا من الأُلفة، يُذكّرك بأنّك ما زلت جزءًا من ذاكرةٍ أوسَعَ من المكان واللغة.
لِهذا نَحن نَرسُم فلسطين. ففي كلّ لحظة يُرفع فيها علم، تُرسَم فيها بطّيخة، أو تُرتدى فيها كوفيّة يَحدث تَماسٌ بَين الذاكرة والفعل السياسيّ، بين الفَرد والجَماعة، بَين مَن يَعيش المَأساة ومَن يُسقَط عليه تأثيرها عن بُعد.
في زمنٍ صار فيه التضامن فعلاً رقميًا سَريع الزّوال، يَبقى الفنّ أَحَد أَكثر أَشكال التّعبير استمراريّةً — لأنّه لا يكتفي بالقول، بل يُعيد للإنسان إحساسَه بالقُدرة والمَعنى.
يَعمَل الفنّ كآلية لتنظيم النّفْس وإعادة ترتيب الفَوضى الداخليّة؛ يَمنَح الإنسان قدرة على تحويل الخَوف والغضَب إلى شكلٍ يمكن فهمُه والسّيطرة عليه. في الرّسم والكتابة والعَزف، يَجِدُ الناس مساحةً آمِنَة للتّعبير وللتنفُّس، فيتكوّن نوع من الاتّساق بين ما يَشعرون به وما يَستطيعون قولَه أو إظهاره. لذا، يمكِننا القول إنّ الفنّ في التجربة الفلسطينية هو ممارسةٌ للبقاء، وطريقة لحماية المَعنى في مواجهة الفقد والعنف.
الإبداع، في هذا السّياق، يَحمِل وظيفة علاجيّة واضحة: يُعيد للفرد إحساسه بالفاعلية (agency) بعدما فَقَد السيطرة على مُجريات حياته، ويَمنَحه وسيلة لتجسيد الألم بَدَل ابتلاعه. وحين يرسُم أَحَدهم بلده أو يغنّي عنه، فهو يساهم بشكلٍ مباشر في بناء ذاكرة جماعية متماسكة تؤكّد الوجود وتربط الحاضر بالماضي. هو لا يَستَدعي الماضي فقط، بل يُعيد بناءَه بطريقةٍ تَسمَح له بالعَيش معه. بهذه الطريقة يتحوّل الفن إلى أداة لبناء الهويّة واستعادتها — ليس فقط هوية وطنية، بل أيضًا نفسيّة وشخصيّة، تُذكّر الإنسان بأنه ما زال قادرًا على الحركة والتّأثير تحت سطوة القَهر.
تُظهر دراسات علم النفس المجتمعي أن الممارَسَة الإبداعية الجماعيّة تخفّف من القَلَق، وتقلّل الإحساس بالعَجز، وتَخلِق روابط اجتماعيّة تُعيد للناس إحساسهم بالانتماء.
تَنتَشر في أنحاء فلسطين ورشات الفنّ المجتمعيّ كأداة علاجيّة، يُعبّرون في هذه المَساحات الآمنة بالألوان والأَصوات والحركات عن واقعٍ تَضيق به الكلمات. يصف المشاركون في مثل هذه الورشات بأنها “طريقة لتنظيم الفوضى في الداخل”، وبأنّها مساحة "تفريغ" و"حريّة". الفنّ هنا لا يعمل على المستوى الجماليّ، بل على المستوى النفسيّ والسياسيّ — تحويل الانفعال الخام إلى حَرَكة منضَبِطة، واستبدال العجز بفعلٍ رمزي قادر على منح الاتّزان.
لكنّ القيمَة الأَعمق للفنّ تتجلّى حين يتحوّل من فعلٍ فرديّ إلى فعلٍ جَماعيّ. في الأغاني والجداريات والورشات الجماعيّة والدبكة الشعبيّة، يتجسد مفهوم الصمود (Sumud) الذي يَصفه علماء النفس التحرريّ بأنه شَكل مِن أشكال المقاومة- تحويل الوجود اليوميّ نفسه إلى موقفٍ نفسي وجَمعي سياسيّ يرفض الانكسار. الفنّ الجَماعيّ يُعيد للناس إحساسَهم بالانتماء حين تتفكّك البُنى الاجتماعية والسياسيّة، ويحوّل الأَلَم إلى رابط مشتَرَك يُبقي الذاكرة والمعنى أحياء، بدل أن يَترُك الفرد في عُزلة فرديّة.
على الجانِب الآخر من الجدار، يتحوّل الرّمز إلى امتدادٍ نفسيّ للفن، وإلى وسيلة تتيح للذاكرة أن تَعبر المسافة بين مَن يَعيش التّجربة ومن يتضامَن معها.
في السّياق الفلسطيني، تؤدّي الرموز دورًا يتَجاوز الدّلالة السياسيّة. فهي تستحضر ما يُسمى “الاستجابة اللاواعية للرمز”، أيّ تلك المشاعر التي تَنبع مباشرة عند رؤية شكلٍ مألوفٍ دون حاجة إلى تفسير. رُؤية الكوفيّة أو ألوان العَلَم الفلسطيني تُثير إحساسًا فوريًّا بالانتماء والذاكرة والاستمرار، كأنّها تنقل رسالة صامتة بين الوعي واللاشعور.
الكوفيّة بَدَأَت كَقِطعة قِماش يستخدمها الفلاحون للحماية من الشّمس والغبار، لكنّها مع ثورات الثلاثينيات والانتفاضات الفلسطينية تحوّلت إلى عَلامة هويّة. صارت في المخيلة الشعبيّة رمزًا للثبات، ثم تجاوزت حدود الجغرافيا لتصبح تعبيرًا عن التضامن الإنساني. حين يَرتَديها مُتَظاهر في لندن أو برشلونة، فهو لا يقلّد ثقافةً بَعيدة، بل يُشارك في مَعنى عالميّ يتّصِل بالعدالة والحرية والانتماء إلى الإنسان قبل الحدود.
في المقابل، اكتَسَبَت البطّيخة حُضورَها الرمزيّ من البَساطة. أَلوانها الأَربَعة — الأحمر والأخضر والأسود والأبيض — تَستدعي ألوان العلم الفلسطيني، لكنّها تَفعَل ذلك بذكاء هادئ. وُلد هذا الرّمز في لحظات القَمع حين مُنع رفع العَلَم، فتحوّلت البطّيخة إلى مساحَة مقاومة ناعمة؛ تعبير بصري يمرّ من تَحت الرقابة ليصدَحَ بما لا يُسمح بقوله. ومَعَ انتشارها حول العالَم، أصبحت علامة تضامن تُشارك على الجدران والشاشات بوصفها فعلَ مشاركة وجدانيّ، يربط بين مَن يعيش المعاناة ومَن يتفاعَل معها.
يَفتَح هذا الشّكل من الانتشار بابًا جديدًا للتّواصل النفسيّ. فحين يرى الفلسطينيّ رمزه في مكان بَعيد، يشعر بأنّ ذاكرته لم تُعزل، وبأنّ ما يعيشه لم يُعَد تجربة خاصة. الرمّز في هذه اللحظة يعالِج أَثَر الصّدمة الجماعية من زاوية مختلفة: يَخلِق علاقَة مشارَكة بَدَل العزلة، ويَمنح للوَجَع مَعنى يُمكن احتماله عَبر رؤيته متجسدًا ومفهومًا من الآخرين. "أنا أراك، أنا أسمعك، لست وحدك".
الفَنّ والرّموز معًا يَصنعان هذه المساحة المشترَكة بين الفلسطيني الذي يُمارَس عليه الظلم، والفلسطيني المنفيّ ومن يتضامَن معهما — مساحة تنقل التجربة من كونها أَلمًا فرديًّا إلى ذاكرة جمعيّة تشترك فيها الذوات من مواقع مختلفة. يُنظر إلى هذه المشاركة بوصفها عملية معالجة رمزيّة للصّدمة الجَماعيّة، أيّ تحويل الصّدمة من عبءٍ صامت إلى مادةٍ مرئيّة يمكن العمل عليها، وإعادة تَشكيلها في الوعي العام. وحينَ تُرى المعاناة وتُفهم، تبدأ أولى خطوات التّعافي — ليس كنسيانٍ، بل كقدرةٍ على تحويل الأَلم إلى مَعنى وفاعليّة، وهذا بحدّ ذاته فعلٌ سياسيّ.
لكنّ الرّموز لا تَبقى حيّة تلقائيًا. فهي تَحتاج إلى وعيٍ يحميها من التحوّل إلى شكلٍ بلا مَضمون. كلّما اتّسع حضور الكوفيّة أو البطّيخة في الفَضاء العام، ازدادَت احتمالات انزلاقها إلى الاستهلاك السّهل. حين تُستخدم دون معرفة تاريخها أو دلالتها، وتَفقِد تدريجيًّا قدرتها على حمل الذاكرة التي وُلدت منها.
الكوفيّة مثلًا، التي كانت لعقود رمزًا للصمود والانتماء، وجَدَت طريقها إلى صناعة الموضة العالميّة. صارت تُباع بألوان متعدّدة وتُرتدى في سياقات بعيدة عن أصلها، وهذا التحوّل لا يُلغي قيمَتها، لكنّه يكشف هشاشَتها. فبقاء الرّمز مؤثرًا يعتمد على الطريقة التي يُستخدم بها وعلى الوَعي الذي يرافقه.
البطّيخة أيضًا تَسلك مسارًا مشابهًا. انتشارها عبر وسائل التّواصل منحها حضورًا واسعًا، لكنّه أحيانًا جعلها شعارًا بسيطًا يَخسر معناه السّياسي والنفسي. وربما يُصبح استخدامها متاخِمًا للتضامن المُريح (Comfort Solidarity)، أيّ التعبير السريع عن الدّعم الذي يمنح صاحبه شعورًا بالرضا، لكنّه لا يضيف شيئًا إلى فَهم التجربة أو مواجهة واقعها.
في المقابِل، يعيش الفنّانون والناشطون الذين يحاولون الحِفاظ على صِدق الرّموز ضغطًا نفسيًّا متزايدًا. الاستمرار في حَمل المَعنى، وإعادة إنتاجه وسط الإيقاع المتَسارع للتضامن الرَقَمي، يخلق حالة من الاحتراق النفسيّ (Burnout) وفقدان الإحساس بالجدوى. حين يتحوّل الفنّ أو الرمز إلى روتين إعلامي أو واجب أخلاقي متكرّر، يفقد كثيرون الرّابط العاطفي الذي كان يمنحهم القوّة في البداية. يَصِف بعضهم هذا الشعور بأنّه "الفَراغ بعد الانفعال" — لحظة يُستنزف فيها الأمل بسبب التكرار من دون أثرٍ ملموس.
هذا الاستنزاف لا يَقلّ خَطرًا عن الصّدمة الأصليّة، لأنه يُنتج فقدانًا بطيئًا للمَعنى. الرّموز والفنّ لا يشفيان بمجرد وجودهما؛ يَحتاجان إلى إعادة تأمل وارتباط واعٍ بجذورهما حتى يستعيدا دورهُما كأدوات تَواصل ومعنى وفاعليّة. فعندما يُستخدم الرّمز كإيماءة سريعة، يُستهلك، لكن حين يُمارس الفن كفعل تفكير واستمرار، يعود ليكون مساحة فعل سياسيّ-نفسيّ لإحياء الأَمَل بدل استنزافه.
قوّة الرّموز الفلسطينية لم تكن في انتشارها، بل في صِدقها. قيمتُها تنبُع مِن القصص التي خَرَجت منها، ومِن الناس الذين واصلوا استخدامها وهم يُدرِكون أثقالها. وحين تُستعاد في سياقٍ واعٍ يِحترم جذورها، تبقى قادرة على أداء دورها الأصلي: أن تَفتح نافذة على الذاكرة، وأن تمنح من يراها معنىً متجددًا بدل أن تتحوّل إلى عادة مُفرغة.
في التّجربة الفلسطينية، لا يَنفصل النفسيّ عن السياسيّ، ولا الفرديّ عن الجماعيّ. فمحاولة الحفاظ على الاتزان الداخلي هي في الوقت نفسه دفاع عن الوجود الجمعي. الفنّ والرّمز يَعملان في هذه المنطقة المشتركة: الفنّ يعيد بناء الداخل كي يستطيع احتماله، والرّمز يفتح الخارج أمام مشاركة أوسع للذاكرة.
الفنّ هنا ليس تجربة شخصيّة فحسب، بل فعل جماعيّ يخلق لغة مشتركة للنّجاة. حين يرسُم الناس معًا، أو يغنّون، أو يملؤون الجدران بألوانهم، فهم يعيدون تنظيم الألم في شَكل يُطيق المرء حملَه. وفي اللحظة نفسها، يصبح الرّمز — الكوفية أو البطيخة أو الأغنية — وسيلة تواصل بين من يعيش التجربة ومن يتضامن معها، فتتحوّل المعاناة من عُزلة إلى علاقة.
قوّة الفنّ والرّمز لا تأتي من جمالهما، بل من كونهما يَربطان النفوس ببعضها في وجه التفكّك، ويحوّلان الفعل الإنساني البسيط إلى مقاومة متماسكة. في هذا التداخل بين العاطفة والّسياسة، بين الداخل والجماعة، يتكوّن المعنى الحقيقيّ للتضامن: أَن نَستَمر في الفعل، لا لأنّنا نملك الأمل، بل لأنّنا نحافظ من خلاله على وجودنا.

علا وتد
أخصائية نفسيّة. حاصلة على ماجستير في علم النّفس الإكلينيكي. تهتم بدراسة التروما وعَلاقات التّرابط في سياق المجتَمَعات العربية.