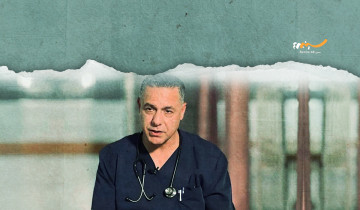حينَ يُمسي المَكان أَثَرًا: ذاكِرَةُ المَدينَة الغائِبَة

المَدينة التي تَسْكُنُنا
غزة، ذلك الاسم المتفرّد بثقله يَمنحنا بِطاقة تعريف تتناسب مع كثافة تجربتنا، لا بجغرافيا عَمارتها فحسب؛ فهي ليست اسمًا على خارطة تنهشها المَواسم المتعاقبة للحروب والأزمات، بل مدينة مشحونة بطبقاتٍ من المَعنى، تَحشد في حَواريها وساحاتها وأسواقها العتيقة نبضًا لا يَسكن مهما عَصَفت به المواسم ولفَحته رائحة البارود.
تَأخُذنا هَرولة النزوح في رحلة نجرّ خَلفنا مدينةً لا تُشبه خرائط الأرض، مدينة تتكون من طين الروح وشَذرات الوجوه المفقودة. يتكون الأَثَر فيها من رغيف فَقَد هويته، إذ عَجِزنا عن الظفر بقبضة طحين واحدة، فصار الخبز هَباء نَخلطه من شعير الدواب وحَبّ الطيور، نعجنه بأنامل الذُّعر تحت وطأة الحاجَة وحنجرة الموت، نُراقب عجينه المتهالك في يأسٍ أن يتماسك، وكلّ عضةٍ منه تَسرد جوعًا لا تهدأ فيه الروح بل تزداد هشاشةً في مساءات الخراب.
فتتقاطَع مع مقهى تَحتَضن طاولاتُه ضحكات خنقتها الأيام من فُرطها ذات مرّة وعلّقتها كأطياف في زوايا المقهى، ووجوهنا المنحَسرة في قعر أكواب قهوة "سمارة" انسكبَت منها نشوة مؤقتة وكأنّها خلاصة سعادة هاربة أجهَضها الوداع.
نَسير في ليل مغمور بالرصاص وإخلاءات متكرّرة؛ لتخطّ أقدامنا طريقًا يحتضِن سجلّ غزة العَتيق من "المسجد العمري" الذي يشهد على تَعاقب العصور إلى "حمام السمرة" الذي احتفظَ بأنفاس الألف عام وعطر الطائفة السامريّة والأيام الحميمة. هنا، يَذبُل حيّ الهوية، تتلاشى حروفُه على جدران المَنازل القديمة ويخبو دفؤُه عن شرفات تستظلّ بالفراغ، وتَصنع سيمفونيةً حزينة تتداخَل أنغامها مع مَواكب النزوح وهم يشدّون بقايا الذكرى إلى أكتافِهم.
فُسُحات من الحَياة في مدينة منفيّة
تُردفني الشّوارع أصداء التاريخ بَعد مبيت على أبواب مَحال شارع "عمر المختار" الذي يمتد من "ميدان فلسطين" إلى "ساحل الشاطئ"؛ فأغدو جُزُرًا من الخُطى متناثرة فوق إسفلتٍ أعجَزُ مِن أن يُلملم شتاتنا مثقوبٍ بندوب الفقد ومخضبًا بوهج الذكرى.
حيث يُغلّفني الفجر بِحيرَة نسماته المغتربة وأنا أتسلّل بين دفّتي بطانية أمي علّها تعيدني إلى ذلك الدفء الذي كان يتدفّق من فرن البيت وتَعبق منه رائحة كَعك العيد، تتمايل حولها نقاشات عائلية شهيّة حول أيهما أشهى: المعمول بالتّمر أم ذاك المطوّع بمعجون الحلقوم والمفروش بالفستق الحلبي، تزدحم في رأسي وتُدغدغ روحي، حتى أَجِدني أدندن همسًا: "يا ليلة العيد آنستينا".. بالفعل آنستينا. كأنّها أُمنية مؤجلة في وحشة الأيام، تَغزل في أعماقي خيطًا من الدفء لَن يقطعه صَرير الرّصاص.
يَحملني الطريق، خطوةً إثر خطوة إلى ذلك المنعطف القديم حيث تقف كنيسة "القديس بورفيريوس" كحارسٍ لهوية قديمة وسط الأزقة المتعَبَة؛ وتَنهض دهشتي الأولى هناك، إذ ابتلعت ريقي أَمام عَظَمة عمارتها الداخلية وطار قلبي بين ممراتها باحثًا عن قَبس يَروي عطشي للتراث الثقافي. جدرانها الأثرية تتلاحم بمسجد "كاتب ولاية" موشاة بخيوط التآخي التي لا ينطفئ وهجها في غزة، حتى ألتفت يسارًا وينثال الزّيت على عتبة الدار مبلِّلًا الحجر القديم في مطعم "بيت ستي الأثري"؛ فتتصاعد رائحة الزعتر، كأنّها تُعمّد المكان بصلابة الأرض وذكريات الجدّات في ليالي الطمأنينة. تغدو مدوّنة سرية لجغرافيا الحياة اليومية، حيث اعتادَ الفرح أن يستلقي على عتباتها ويوقِظَ زائريها في ليالي الأعياد ومواسم الطمأنينة القديمة.
من النزوح إلى إرثٍ جديد
يَشتد وطيس الحرب ليمتد أَمَدُه اللعين إلى عامين متكاملين؛ فتضطرم خطانا بالهروَلة غربًا، تتوشّح أسماؤنا ببقعة أمل جَسور لا تجد حضنًا يضمّه، باحثين عن فسحة أمان في نَصل الريح؛ فتهوي الذاكرة بِنا عند رائحة قهوة "بدري وهنية" التي تَعبُر في "حيّ الرمال" مثل وعود صغيرة تُحرّض أرواحنا على الثّبات، وتُشعل في ذواتنا نار الانتماء الحيّ، فلا تغفو عنّا ملامح المكان مَهما تَعاظمت خطانا في منفى غرب المدينة.
وتَبتسم لي مرايا مطعم "بيليني" من الأعلى، حاضنة انعكاس وجهي ووجوه رفاقي في فضاء يعجّ بدفء الحركة وصخب الصباح وسط المدينة، حيث تتسرب رائحة المكان في طاولة فطور صباحي تتعانَق فيه ضحكات الأصدقاء، وأصداء لقاءات الأمس مع رائحة الخبز والقهوة كأنها قُبلة أبدية من وجدان المدينة المستباحة. ويمتد مَسار النزوح حتى "مسمكة أبو حصيرة" على شاطئ البحر، نهاية مؤقتة لمتاهتنا، حيث يتبخر السؤال الأثقل "إلى أين الآن؟" خلف رائحة شواء السمك المضمّخ بأثر اللقاء الأخير.
جَغرافيا الذّاكرة: كيف يصنع الهدم إرثًا جديدًا؟
يَتَبلَور مفهوم الهَدم في غزة في فقاعة يتّسع مداها لطيفٍ تتراقص ألوانه على قوس قزح من الذكرى؛ فتخلق طبقات من الدَّلالات والهوية في وجداننا. حين تنهار الملامح القديمة لـ "سوق الزاوية"، وتُقتلع عناقيد العِنب من أراضي "الشيخ عجلين" التي كنّا نتسامَر على وقع قَمَرها وتتزاحم النكات وتتكاثر الضحكات، أو يُهدم بيت الطفولة أو يُسوى حيّ كامل بالأرض؛ تتقافز الصورة المهدَّمة لتُلقي بأشعتها وتعيد رسم خرائط حَفَرتها الذاكرة على جدران القلب الهشّ في حضرة صلابة المشهد. هكذا يَفرض الهدم علينا حكاية تاريخٍ جديد، أكثر حياة وصخبًا.
ذلك ما يعضد روح الغزّي في لَحَظات الفَقد، حيث تتملكه ذاكرة المدينة الغائبة وإرثها غير المادي؛ فتتزاحم أمامه الصور، وتقبض إحداها على روحه لِيَجد نفسه بين الحكايا المسائية عند "ميدان فلسطين"، وتُلقي نكهة مخبوزات "السّودة" ونمورة "تيّم" -تلك الحلويات الشرقية الشهيرة- المغبونة بالسمن البلدي بظلالها على مشهد مُسَرّج بالحنين للأعياد، وتُبحر في صدى القهقهات التي كانت تَدُب في زوايا "الجُندي المَجهول" الذي يَحمل في رخامه أسرار التضحيات الأولى وجذوة السؤال الذي لا يَخبو.
إنه صدىً ينتقل إلى كزدورة مثقَلة بالأَثر، تزخر بكل شيءٍ، تتحسّس بها سنين عمرك، حتى تعود فجأةً بلا أيّ شيء، إلى كلّ الأماكن إلا إيّاكَ. عندها يتخمّر الشوق ويصنع رغوةً تمنح الذاكرة القُدرة على تجاوز الخراب مهما تعددت المسارات وتبدّلت الخرائط والوجوه، وتحطّ بك عند أوّل محطة للإرث الجديد.