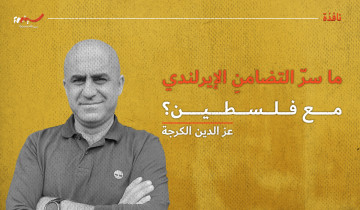الفَنّ الفِلِسطيني: عِندَمَا "تَرْسُمُ" الحَربُ حُدودَ الحَيّز والمَعنى

هذا المَقال محاوَلة لتتبّع التّحولات التي تشهدها الممارسة الفنيّة الفلسطينيّة في السنوات الأخيرة، من موقِع التجربة الشخصيّة والملاحَظة الميدانيّة، داخل الحقول التي تعمل تَحتَ المنظومة الإسرائيلية، وأخرى مستقلّة، في الحرب، حيث يصبِح السؤال عن دور الفن أكثر إلحاحًا، ليس بوصفه ترفًا جماليًّا، بل فعلٌ مرتبطٌ بالبقاء، وإنتاج المعرفة وكيفية تمثيل الذات في فضاء خاضع للرقابة والسيطرة.
يركّز النصّ على المقارَنة بين المساحات المؤسّسية الإسرائيلية التي تُقدَّم كأماكن مفتوحة للعرض والتّعبير، لكنها في بنيتها أداةَ هيمنة وإعادة إنتاج سيطرة، والمساحات الفلسطينيّة المستقلّة التحرّرية. من خلال تجربتي في مجموعة "إطار" في القدس، أُحاول فَهم ما يمكن أَن يفعَلَه الفن في سياقٍ تتهاوى فيه الحياة اليوميّة تحت وطأة الحرب والرقابة، في حين يعيش الفنانون والفنانات الفلسطينيون تساؤلًا دائمًا حول دور الفن وجدواه وأبعاده الأخلاقية.
تبدو المساحات الفنيّة التابعة للمؤسسات الإسرائيلية في ظاهرها أماكن متاحة ومهنيّة، تمنح الفنان الفلسطيني أدواتِ إنتاج وتمويل وعرض. لكنّ هذه الحرّية التي تَعِد بها ليست فعلًا حقيقيًّا، بل شكل من أشكال تنظيم الحدود الدّقيق، تُدار تحت مفرَدات مُطَمْئنة مثل التعدّدية والتّشاركية. عَبرَ هذه المفرَدات، تُعاد صياغة علاقات القوة بطريقة ناعِمة وفعّالة. فيها يُشجَّع على التّعبير، لكن بشَرط أن يكون صوته متفهّمًا ومضبوطًا.
منذ المراحل الأولى في التعليم الأكاديمي، تُصنِّف المؤسَّسَة الفنان الفلسطينيّ قَبْل أنّ يعرّف نفسه. في الواقع لا يوجد ما يمكن تسميته فنًّا فلسطينيًّا داخل المؤسّسة الإسرائيلية، بل هناك أَفراد فلسطينيون ينتِجون داخل فضاء إسرائيلي الهويّة، ويُقاس حضورهم بمدى قابليّتهم للتّمييع أو مقاومتهم له. حين يُنتج أحدهم عملًا سياسيًّا يصعب احتواؤه تُسارع المؤسّسة إلى تصنيفه كفنّ فلسطيني، لا اعترافًا بهويّة جمعيّة فنيّة، بل لتأطيره ضمن خانة يمكن استيعابها لتزيين المَشهد أو عَزلها. قد يبدو هذا التّصنيف سطحيًّا، لكنّه فعّال جدًا في تشكيل وعي الفنّان بذاته وبحدود موقِعِه.
مَع اندلاع حرب الإبادة على غزّة، تَكشّف هذا الوَهمُ أكثر من أيّ وقت مضى. أَصبَح الخطاب الفنيّ الفلسطيني خاضعًا لمراقبة أوضح: تُراجَع النُّصوص المكتوبة لصالات العَرض، وتُطلب تعديلات على العِبارات، ويشجَّع الفنان على الحديث ضمن قاموس لغويّ مَضبوط يحافِظ على "الحِياد الإنساني". في هذه الأَجواء، لا تَفرض المؤسّسة رقابتها علنًّا، لكنّها تَخلِق مناخًا من الخوف يجعل الفنان يراقِب نفسه، يَحذِف، ويُعيد صّياغَة وَجَعِه ضمن ما يُسمح له أنّ يَحزَن عليه.
في مقابل، الفردانيّة التي تعززّها المؤسَّسة الفنية الأكاديميّة بالعموم، تُنشئ مبادَرات فلسطينيّة تَعمل على بناء فضاءات جماعيّة مستقلّة. من بينها "إطار" في القدس، وهي مَساحة فنيّة أسَّسها وفعّلها الفنّانان علاء بدران ونوران جولاني بمشاركة عدد من الفنانين الشباب. شاركت في هذه المجموعة السّنوات الثلاث الأخيرة التي تزامنت مع الحرب، مثّلت المَجموعة نموذجًا لمساحة تعتمِد العمل الجَماعيّ والحوار كوسيلة إنتاج معرفيّ وفنّ بديل. في دورته الثالثة (2024-2025)، اتّجه "إطار" نحو دعم إقامة سلسلة من المَعارض الفرديّة للمشاركين، وعَمِل على التشبيك مع مؤسّسات ثقافية في بيت لحم.
تنوّعت الوسائط الفنيّة التي استخدمها الفنّانون والفنانات في المعارض بين البّاطون، والكِلْس الأبيض، والقماش، والفيديو، وغيرها. تقاطَعَت المَعارض حَول ثيمات الفَقد، والموت، والمجهول، والضياع، بوصفها مكوّنًا مركزيًّا في التجربة الفلسطينيّة الراهنة. تحوّلت هذه المعارض إلى مساحات أقرب إلى المَتاهَة البصريّة والروحيّة، وغَلَبت عليها الألوان القاتمة التي عَكَست ثِقَل المرحلة.
في أعمال مرجان غنايم، يتحوّل الدّعاء للميّت إلى مادّة حسيّة تستكشِف الهَشاشة بين الحياة والموت، بينما تَستَخدم شيماء شيخ علي الجَسَد كأَداة لمساءَلة العجز والمقاومة، متجاوِزة تجربتَها الذاتية في الحيّز لتُشرِك المتلقيّ في سعيه نحو الانعتاق والخَلاص. يَستَعيد نديم مازن صورَة الأَب والبَيت من خلال لُغة لونيّة تَربط الفَقد بالذاكرة، ويقدّم عملًا تفاعليًّا يدعو الزائر إلى إعادة التّفكير بمن فَقَد. أمّا نور جبارين، فتنقّب في الأرشيف والظلال لإعادة التّفكير في مفاهيم الهويّة والزمن، في حين يوسّع عبيدة دحلة المَشهد ليواجِه المَنفى الجغرافيّ والداخليّ معًا، متتبعًا أَثَر الاغتراب القَسري في علاقة الفلسطيني مع مكانه الأوّل.
 |
|---|
منظر عام من المعرض. الفردي، الملائكة x4 ، للفنانة مرجان غنايم تصوير روان جولاني
جاءَت بَعض التّركيبات بسيطةً تقنيًّا، تترُك للفَراغ دورَه كصوتٍ آخرَ في المَعنى. في تجربتي الشخصيّة، اضّطررت إلى التّخلي عن المَواد الثّقيلة لصالح خيارات أخفَّ مِثل القماش والفيديو، ليس فَقَط بدافع المَفهوم، بل بفعل الواقع الماديّ للحرب: صعوبة النَّقل، وانقطاع الطُرق، والخطر الناتج عن القَصف. بهذا المَعنى، تسرّبت الحرب إلى الأعمال، لا بوصفها مضمونًا سياسيًّا فحسب، بل كَشرطٍ إنتاجي أثّر في الشّكل والمادة والإيقاع معًا.
 |
|---|
منظر عام من المعرض الفردي، منفى العين، للفنان عبيدة دحلة
في هذا المَشهد المليء بالتحوّلات، يُصبح الفنّ الفلسطيني ممارسةً متوتّرَة بين القَيد والجَدوى. فالمَساحات المستقلّة مثل "إطار" لا تَملِك موارد ماديّة كتلك التي تمتلكها المؤسّسات، لكنّها تمتلك ما هو أكثَر نُدرة: الوَعي الجمعيّ والرَّغبة في خَلق مَعرفة مِن داخل الجَرح لا مِن خارجه. هذا العَمَل الجَماعيّ لا يُلغي الفَرد، لكنّه يُعيد تَعريف حُضوره ضمن شَبكة من التضامن والتفكير المشتَرَك، حَيث يُصبِح النّقاش والمساءَلة جزءًا من العمليّة الإبداعيّة نفسها.
 |
|---|
منظر عام من المعرض الفردي مجهول ٧٨١، للفنانة نور جبارين
مَع أنّ هذه المَساحات تُحاول الانفصال عن المَنظومَة الاستعماريّة، فإن تأثيرها يظلّ قائمًا: في القيود على الحَركة، في الملاحَقَة، في محاولات العَزْل والإقصاء. لذلك، يظلّ سؤال الجدوى حاضرًا: ماذا يمكن أَن يَفعل الفّن في زمن الإبادة؟ هل يُمكن للجَمال أن يكون موقفًا أخلاقيًّا، أو شكلًا من أشكال الفَهم البطيء للكارثة؟
ربما لم يَعُد ممكنًا الحديث عن الفنّ كملاذ، بل كمساحة اختبار للوعي. فالحرب لم تنتهِ، بل تتبدّل أَشكالها، وتستمر ببطءٍ في إعادة رسم حدود الحيّز والمَعنى. في هذا الواقع، لا يقدّم الفنّ إجابات، بل يصرّ على طَرح الأسئلة: عن الوجود، عن الذاكرة، وعن الحقّ في بناء المعرفة وتشكيلها في أَحلَك الفترات التاريخيّة.
الصوّر: لمعرض "إطار"، بتصرف.

دلّة طربيه
فنّانة بصرية تتنوّع أعمالها بين الفيديو، والأداء، والتّركيب، والنّص. تستكشف من خلال قصص شخصيّة الفَضاء وتفكّك تمثيلاته النصيّة والبصريّة والصوتيّة. حاصلة على بكالوريوس في الفنون التشكيلية واللغة العربية، وماجستير في الفنون الجميلة من جامعة حيفا.